أين ذهب الوقت؟
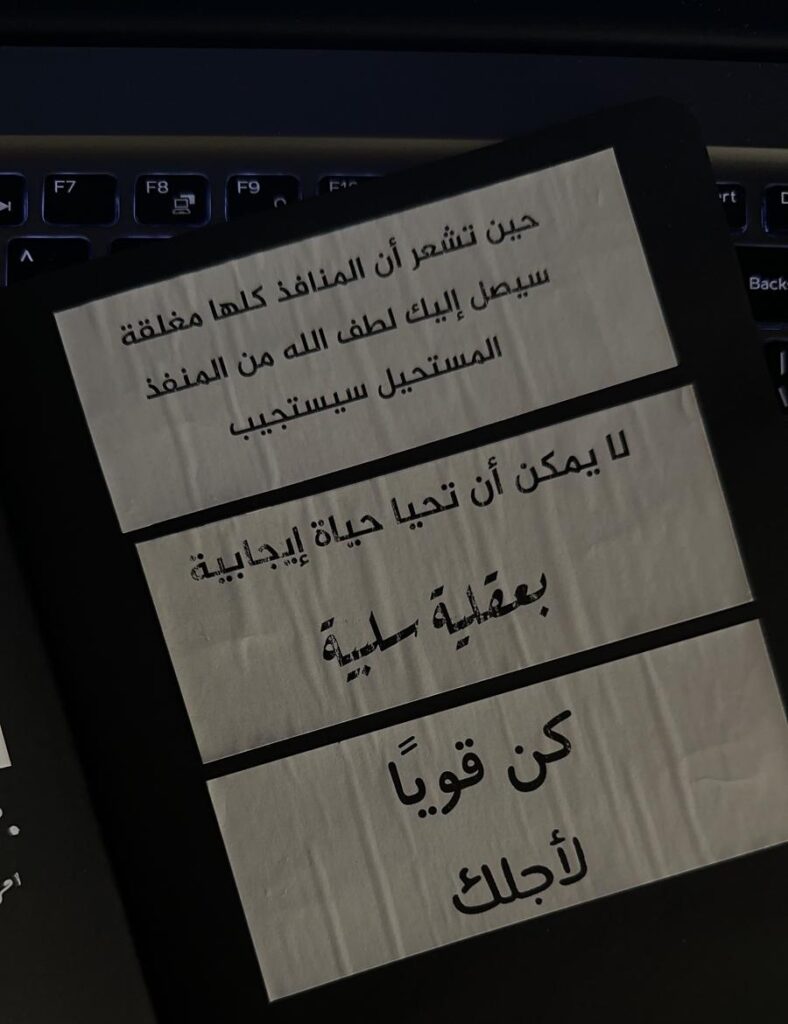
نهاية شهر تموز عام ألفين وثلاثةٍ وعشرين، يوم افتتاح هذه المدونة العزيزة. سنتان ويزيد، مع تسعَ عشرة تدوينةً فقط!
بدأت الكتابة أو بالأحرى اكتشفت أنني مهتمة بها في عمر الثالثة عشر، انغمست كثيرًا لسنتين ثم دخلت المرحلة الجامعية، فكأنها نفقٌ سحري، أفقدني الذاكرة وتخليت عن الحروف، لتتخلى عني. بعد التخرج من الجامعة تنفست الصُعداء لكن اختنقت بالواقع، ماذا سأفعل الآن. عملت لسبعة أشهر ولم أشعر بتلك الشرارة، عن أي شرارة أتحدث -أنا نفسي لا أعلم- وليس غريبًًا عليّ ألا اعلم ماذا أريد، لكن حاولت ترجمته، فنتج معي أني لم أشعر بالاكتفاء، نعم وظيفتي مريحة وزملائي الذين أصبح بعضًا منهم مقربين جعلوا بيئة العمل ملاذًا، لكن لا، هنالك ما ينقص. العودة للكتابة، كانت أول فكرة خطرت لي، كيف ومتى، لم أضع مخططات فقط غطست بلا معدات في بحر “اليوتيوب” ورست سفينتي على طرق النجاح في Blogging.
هذه التدوينة بُدِأت في العاشر من سبتمبر من العام الماضي واليوم تُنشر.
شاهدتُ مقطعًا قصيرًا على “تيكتوك” تقول صاحبته: لو كانت حياتك تُعرض كفيلم أمام العالمين فما هي الحبكة التي سيصرخون فيها: “لا تفعل هذا أو افعل ذاك”، اعتقد في حالتي ستكون في كل مرة أتناول قلمي أو جهازي لأكتب، فيُصيبني داء (سأكمل لاحقًا) أو (هذا ليس جيدًا كفاية، لنبدأ غدًا)، سيصرخ المشاهدون كما لو أنهم يرونني أصافح المجرم على جهالة مني بينما هو من أبحث عنه. في كل مرة سأترك القلم، لوحة المفاتيح، ستهتز الرؤوس بخيبة أمل، الى أن تبدأ الصالة بالتجرد من المشاهدين ليُعرض فلمي عليّ بلا أي إيرادات، بل بخسائر فادحة.
مرت السنين وهذهٍ جلستي وتلك أقلامي، أخطط لغد تُشرق فيه شمس وتغيب. اتحجج بانتظار أشعتها لتنير دربي لكنني مُقيدة… ما حُجتي اليوم؟
لم أواصل يومي بعد صلاة الفجر، فنمت، واستيقظت في الثامنة لذا انتهى اليوم وسأبدأ غدًا، سأكمل اليوم بمشاهدة ما يُنمل العقل وآكل ما يُفسد البدن وأتجاهل خوفي لأنني سأبدأ غدًا بدايةً جديدةً نظيفة.
مما أخاف؟
من الفشل بعد الجهد المُضني إذًًا؛ لا جهد مضني: فإما نجاحٌ بالكاد أو فشلٌ غير مؤلم.
عندما تدور طاولات النقاش ويُطرح موضوع الكسل يرتجف قلبي قليلًا فهل تُراك تنتبه لي عزيزي القارئ؟ أ ترى نظرة الانكسار، كأن ظل الجلاد أطلَّ عليَ، وإن لم يُعاقبني، فقط الظن بإنه في الغرفة، كافي لهز رُكبي. اراقب نفسي أ سأنهار واعترف بأني لستُ العظيمة التي تنجز باستمرار، لستُ النحلة النشيطة بل أنا الفراشة الجميلة التي تتنقل بانسيابية بين الازهار-تُفيد بالطبع- لكن ببطء عجيب وعرض مهيب.
أ الكسل عينه التسويف، أظن ذلك، ولا أحب التبريرات “السيكولوجية” في هذا الموضوع خصوصًا.
لا أحب أن أكون ضحية ولا أتعامل مع مُتبنيي عقليتها. إن ساقت لك الدُنيا بمصيبة ووقعت ضحيتها فأحزن، وابكِ مُصابك الإثنين ثم عُد للعمل الثُلاثاء. دع تلك المُصيبة تنقع في داخلك وتأمل الدُنيا بها، لكن لا تدعها عذرًا لكل خطأ تقوم به أو تستعطف قلوب الناس بدنيء خُلقك ليبرروه لك. أنا لم اتطور ككاتبة لأن العمل اشغلني، حياتي ألهتني، وطبعًا لم يقف أي من بني آدم بيني وبينها، بل لأنني انسانة كسولة ضعيفة، بدأت حياتها بعدة كَذِبات ونست خلال الطريق ان تواجه نفسها وتُصلح اساساتها والآن هي تدفع ثمن هذا غاليًا، بمواد أغلى ووقت أطول.
الثقل، الشعور الوحيد الذي يصف حالي. فيزيائيًا ومعنويًا. قلبي مليء وعقلي مزدحم لكن هنالك في الأفق، يقف هو، يشير لي بالبقاء في مكاني حتى لا اتحرر، يريد مني الاستسلام والرحيل بهدوء. اخفضي صوتك، هدئي من روعك، وقللي من كلمكِ، هكذا يتيسر دربك. بلسانه هو. أُريد أن أبرر بأن صوتي، لا يرتفع لغوًا بل هشًا لظلم يجزع من الصوت العالي، روعي مُهتاج لأن الخطأ يمشي بينما الحق يعرج، وكلمي كثير لأن العقول تجبست وتحتاج لدق عنيف -وأولهم عقلي- هذا الرد كان يختبئ وأخاف أن أعلن عنه، لكن مما الخوف، فلتكن هذه السنة حيث أقول ما أريد، لكن قول ما أريد لا يجوز مع ضعف موقفي. الباطل وإن كان باطلًا سيُمسي حقًا إن سار خلفه الكثيرون، والحق الذي أنبح به -مع الأسف- لأنه عشوائي وليس مخطط ومدعوم كما الباطل سيدفن بهدوء!
ضُعف داعمي الحق من ضعف صحة الحق في عقول الطيور، يُصدق الطير مصدر الريح الأقوى وإن كانت زيفًا.
الأمل
ما يُضحكني الآن بينما أكتب هو صدى صوتي في الماضي القريب ونقدي لمن تلاعبت بعقولهم وسائل التواصل الاجتماعي والآن -في رأيي- أنا أسوء منهم. حقًا أنا طبقت مقولة (سيُسقى كل ساق بما سقى)، لأكن أنا تذكيرك بأن ما تعيبه سيعِيُبك، فدعك والخلق، وركز مع نفسك. عُدت لتدوينة السنة الفائتة بعنوان (ميلادًا سعيدًا) و يا ليتني لم أعد، السطر المُعلق لا يزال معلقًا، والحلم الكبير لا يزال في المنام. لكن، حتى نلون هذه الصفحة بقليل من الأمل، بادرت بخطوة مخيفة السنة الفائتة ألا وهي إكمال دراستي الجامعية بتخصص مختلف تمامًا، تلون جلدي بالطبع، كنت حائرة والآن أنا واثقة، أعرف عيوبي أكثر من حسناتي وبدأت أسأل نفسي قبل كل فعل أو قول:” هل يسوى؟”، نعم هذا الفعل مُرهق لكن استحق الكثير من الإرهاق على كم الكسل الذي راكمته.
تعقيبًًا لجرعة الأمل، هدأ روعي. لو قرأت تلك التدوينة مرة أخرى الآن لشعرت بالتوتر معي وبالخوف -لازال الخوف موجودًًا لكن بلا هلع- اقتنعت أخيرًا أن ما افسدته في سنين لن يُحل في سنة، وركضي الدائم لن يُسرع المواضيع بل سيصنع هيكلًا هشًا قد يُثير إعجاب المتفرج لكن مع أقرب عاصفة سأعود لكتابة أسطر مشابهة لتلك، أبكي فيها الحال وأُعزي فيها سنين الشباب الضائع. وقعت بيني وبين نفسي معارك صغيرة خرجت بها منتصرة، لا اذكرهم لكن أذكر بدقة شعور الاحتفال الداخلي برفضي لفعل يُسئ لتقدُمي.
بالطبع عزيزي القارئ وصلت لهنا وتساءلت ماذا تريد مني الكاتبة الآن؟ وأتوقع منك هذا السؤال. هذه التدوينة -اشعر أنني قلتها سابقًا- اعتراف لكيلا أُبتز. الابتزاز عزيزي هو أن تخفي شيئًا، ويكتشف قليل الأصل هذا الشيء فيتلاعب بك كيفما يشاء مقابل إخفاء عيبك. إذًا لتكون المادة قابلة للابتزاز يجب أن يزعجني إطلاع الناس عليها، لذا إما الاعتراف أو حرق كل ما يدل عليها، وبما أن أدلة كسلي إن حُرقت تضيع حياتي مع ذاك الحريق، لذا الاعتراف هو سيد الأدلة وأرفض أن يبتزني-أو تبتزني- نفسي حتى!
لذا أقف -مجازيًا- هُنا وأقول أهم عمل لي في هذه السنة أن أتحول لفراشة منتجة، قد يكون ببطء لكن بفاعلية وبلا صباحات مثالية، لكنه سيصير بإذن الله.
ستكون هنالك نُقطة لذلك السطر المُعلق وهُنا
هذه رسالة خفية، حركة تذكرتها بما أنني أعيد مشاهدة الأنمي الذي كوّن شخصيتي (كونان).
النجاح يحتاج الى مُعايرة دائمة، لا أريد تشبيهنا بالأجهزة، لكن لكل جهاز معيار يمشي عليه لنتأكد من جودته وفعاليته خلال السنين، وهذا المعيار لا علاقة له بأفضلية شيء على شيء آخر -في عالم الأجهزة ربما- أما في عالم البشر فلا أحد أفضل من أحد إلا بالتقوى والتقي الحقيقي لا يمشي مُعلنًا تقواه.
لذا لنهدأ قارئي المتوتر، وقارئي الهادئ ساعدنا نحن المتوترين.
أكتب لكم دائمًا بحب.